نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لكل عاشق وطن..ولكل وطن مواطن جمال, اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 06:37 مساءً
الرفاق حائرون، يفكرون، يتساءلون، يتساءلون فى جنون..
كلمات جاءت فى أغنية عبد الحليم حافظ «حبيبتى من تكون» والتى قد صدرت على أسطوانات صوت الفن فى 30 مارس 1981، أى بعد وفاته وكانت من ألحان بليغ حمدى وكلمات الأمير خالد بن سعود
بالفعل.. الرفاق حائرون
حائرون وهم يتساءلون جميعًا هنا تحت سماء القاهرة، تلك المدينة الساحرة ذات الماضى العريق والحضارة المتفردة، مركز الحراك الثقافى فى الإقليم العربى وبوق بلاد المشرق من عليَة مؤسساتها الوطنية وقِبلَة من يصبو إلى وجود وتواجد تحت الشمس. وهنا استشهد بوصف المؤرخُ عبدالرحمن بن خَلْدون (808هـ/1406م):
«أهل مصر [يعيشون] كأنما فَرَغُوا من الحساب [حساب الآخرة]، ذلك أنهم غَلَبَ الفرحُ عليهم والخِفّة والغفلة عن العواقب؛ فبلادهم هى حضرةُ الدنيا وبستانُ العالم، ومَحْشَرُ الأمم ومَدْرَجُ الذَّرِّ من البَشر، وإيوانُ الإسلام».
حائرون وهم يتساءلون..
لماذا فقدنا البسمة؟
لماذا فقدنا البهجة؟
لماذا نشعر بقلوِبنا ثقيلة وكأنها تحمل وزن أجسادنا بداخلها؟
فماذا حدث لنا؟
البعض يظن أن هذه الحيرة وهذا الشعور الحزين الذى ينتاب الإنسان لهو نتاج أعباء الحياة اليومية المبرحة، والبعض الآخر يرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تضربنا بعنفوان، وآخرون يرون أن ما نعيشه من توترات سياسية غير مسبوقة، جديرة بأن تطير العقل وتزلزل الوجدان.
نعم، بالتأكيد كل هذا حقيقى لأن الواقع صعب ومعقد وحالة التيه وعدم الاستقرار تهيمنان على العالم من شرقه إلى غربه، فهى لا تقتصر فقط على دولة بعينها فى إقليم محدد ولكن للأسف، هذا الواقع المرير يمتد جغرافيًا بإيقاع سريع عبر القارات ويتشعب بخيوط عنكبوتية بين ثنايا العقائد ويتعدى بالخواريزميات متعددة الأوجه على الثوابت المجتمعية، ويتوغل إنسانيًا كالثور الهائج بلا رادع، فينال من ضمير الإنسان ويضعف قوام شخصيته ويطفئ نور بصيرته.
فينتشر ذلك الشعور العام ببلادة المشاعر وانعدام الشغف والأنانية المفرطة ويُصاب القلب فى مقتل ويتحجر العقل، فلا يُدرك إلا الرؤية الأحادية، وهذا ما يحدث من حولناـ مع الأسف ـ فى الآونة الأخيرة.
لماذا أصبح حالنا هكذا؟
هناك شيء ما فُقِد، اختفى وكأنه قد تبخر فى الهواء وأصبح لا وجود له.
هذا الشيء توارى فى زحام الأيام، سقط سهوًا وتركناه وراءنا حتى خفت نوره فى الذاكرة الجمعية للبشرية ووقع فريسة النسيان.
إلا أن هذا الشيء ثمين ولا يُقدر بمال!
فهو بمثابة «رمانة الميزان» فى المعادلة الإنسانية، أى الخيط الرفيع بين سلسلة القيم الإنسانية القائمة على الصدق والأمانة والمودة وحب الآخر وتقبله رغم اختلافه، وبين سلسلة الغرائز التى يتضافر من خلالها المال والسلطة والطمع وعدم قبول الآخر، بل والرغبة فى القضاء عليه والأنانية واللامبالاة أمام مشاهد مفترض أنها تزلزل الوجدان.
من منا لا يجتزئ وقتًا من ساعات يومه لتصفح شاشات الهاتف وتتبع إرسال الأقمار الصناعية والتى تحمل إلينا الكثير من مشاهد الحروب والنزاعات السياسة. ومن منا لا يشاهد تلك اللقطات العنيفة والصور القبيحة معدومة الإنسانية من وقائع قتل وبتر وتعذيب.
هل السياسة هى متلازمة صلابة النفس وموت القلب؟ وحتى لو كان ذلك ـ بالفرض ـ إحدى سمات القائمين عليها من خلال المعتركات الدولية وفق ما جاء فى دروس التاريخ، فهل على البشرية فى الألفية الثالثة أن تبقى على هذا النهج، عِلمًا بأن السياسة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وبقدر أكبر بكثير من أى وقت مضى؟.
وفى هذا السياق، أتذكر الكاتب الفرنسى «جان دورموسون» الذى اشتهر بمساجلاته السياسية مع كبار الشخصيات اليسارية الفرنسية وعلى رأسهم الرئيس الراحل «فرانسوا ميتران»، الذى تحول عداؤه السياسى معه إلى صداقة عميقة بعد أن وحدهما عشق الأدب والشعر والفلسفة وهى أم العلوم.
ورغم الخلفية السياسية اليمينية لـ«دورموسون» فإن ذلك لم يمنعه من امتلاك نظرة متفائلة للحياة، والتأكيد أن الإنسان عليه أن يتذوق تفاصيل الحياة الصغيرة حتى ولو بدت طبيعية فى سياق اليوم غير أنها وبمنتهى البساطة تعنى الحياة وهى من نعم الله على الإنسان.
قال «دورموسون» فى أحد لقاءاته التليفزيونية:
«للهواء والماء أسرارهما وفى آليات الزمن عبرة وخبرة، والعقل المستنير ثراء والقلب العامر بالمودة لا يكُف عن الانبعاث من رماده، وعن اعتلاء منصة السيادة فى العالم!
فالمودة/الحب تجعل الأرض تدور من حولنا وتُشرق الشمس على ربوع العالم الذى مؤكدًا لينهار بدونها.
..
من قبل «دورموسون» بقرون طويلة، كان ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه قد ارتأى أنه «من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف».
فالذى يذوق الشيء هو الذى يعرف قيمته، فحين تتكلم مع إنسان عن حلاوة الجمال، أو تكلمه عن إبداعات الخالق وتجليات الطبيعة وهو لم يتعلم أن يراها ويشعر بمذاقها فإنه لن يدرك ما تعنيه قيمة الجمال، فمن ذاق شيئًا عرفه، فالذى يذوق الجمال يعرفه ولن يستطيع أن يحيا إلا فى رحابه، بل وسيصبح حلقة تأسيسية من فكره ومسلكًا لا غنى عنه فى صياغة حياته.
إلا أن المشكلة التى نعانى منها غالبًا ما تكمن فى غياب فنون التذوق والجهل بمُدرَك الجمال.
فكيف يُدرك قيمة الجمال وهو الذى نشأ وتعرف على الحياة من زاوية ضيقة، أحادية الرؤية فى إطار صياغة يومية ومجتمعية لم تشر له إلى مواطن الجمال الإنسانية والطبيعية من حوله ولم تُعَلِمه فى سنواته التأسيسية الوقوف على تقديرها وتعظيم الاستمتاع بها والاستفادة منها.. فإذا به اعتاد منذ نشأته عدم الالتفات للأشياء البسيطة وعدم إدراك جمالها رغم أن لها مفعول السحر على النفس والقلب، بل وفى كثير من المجتمعات، بات أدب الجمال بروافده كالمحبة والمودة والعشق مشبوهًا وسنسمع من يقول «هذا الشخص يودني.. يا ترى لماذا؟» أو «ما هى المصلحة كى يتواصل معي؟» كلمة «المصلحة» هى كلمة حاكمة للعلاقات الإنسانية فى أيامنا هذه وأميل لتشبيهها بالوحش الكاسر الذى يتوغل بين الأجيال الجديدة ليدمر ثوابت أدب الجمال وتغدو الحياة كاللوحة الباهتة الفاقدة لكل ألوان المشاعر.
يبدو طرحى هذا خارج سياق الحياة الصعبة التى نتكبد عناءها فى الآونة الأخيرة والتى سيعرفها التاريخ بلا شك بـ«الدقيقة» نظرًا لتعقيدها وصعوبتها، ولكنى أعتقد أنه من الواجب على كل من يمتلك قلمًا معبرًا أو منصة إعلامية نافذة أن يلقى الضوء على قيمة الجمال والتى تبدو هنا جوهرية لبناء مجتمعات سوية وقادرة على المضى قدمًا فى سهولة وتناغم مع الآخر، لا سيما معتزة بهويتها ونقاط تميزها.
قبل عشرة قرون، قال الإمام الغزالى فى كتابه «إحياء علوم الدين» إن الإنسان الذى «لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج»٠
أعرف وأكاد أسمع بعضًا من القراء يهمهم ويعترض على استجلاء قيمة الجمال فى هذه الآونة التى يعانى فيها المواطن من غلاء المعيشة، ويحثنى على التحدث عن القضايا الاقتصادية وحلحلة الأزمات الاجتماعية بهدف التخفيف عن كاهل المواطن.
إلا أننى أرى ـ وهذا رأيى الشخصى ـ أن قلب المواطن وروحه هما اللذان يعانيان أكثر من كاهله!.
نعم، الإنسانيات فى أزمة عزيزى القارئ.. فقد انطفأ وهج الروح وتباطأ نبض القلب ولم يعد أحد يعتنى بهما فى عالم قرر أن يعتنق دين المال وعقيدة المظاهر الفارغة على حساب سلسلة القيم الإنسانية الثمينة كالصدق والجمال.
فلا ملامة إذن عندما نرى اليوم مجتمعات قائمة على الربح المادى والتنافس الاقتصادى ويتمحور قوامها حول المال وليس الإنسان الذى تاه فى دروب معقدة حتى خرج تمامًا من دائرة الاهتمام.
فى نهاية مقالى هذا، أود أن أُحذر بأن آفة المجتمع فى العقد الثالث من هذه الألفية هى تعظيم دور المال وملذاته على حساب القيم الإنسانية، فإنه لا سبيل لتقدم البشرية إلا بالإنسان السوى، فالإنسان نفسه هو ميدان للجمال، وحقل نضر لا ينضب أبدًا، وقد خلق الله الإنسان فبلغ به من الإحسان والإتقان ما بلغه ووهبه نعمة الـ«تخلُق» الدائم فى مخاض المشاعر، فهذه المشاعر هى التى تمنحه تاليًا صفته الإنسانية، وماهيته، وتشكيلاته المسلكية، وطريقته وأسلوبه فى التعامل مع ذاته ومع الآخر ولين القلب لا سيما جرأة التفكير وشجاعة التعبير وثقة فى اتخاذ قرارات حياته.
فتجارب الحياة وبالتحديد التجارب الروحية هى دائمًا ما تجعل الروح ترتقى وتصبو للإلحاق بمدارات الكمال والسمو الأخلاقى والمعنوى، فعلينا أن نتعلم من المحن والابتلاءات ونسترجع دروس الإنسانية، فـ«عاشق الوطن» هو من يُدرك مواطن الجمال فى وطنه.













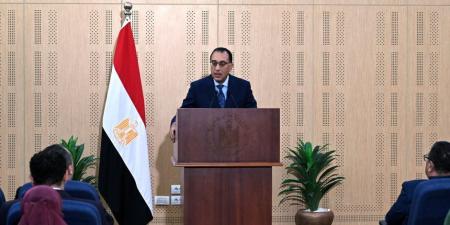

0 تعليق